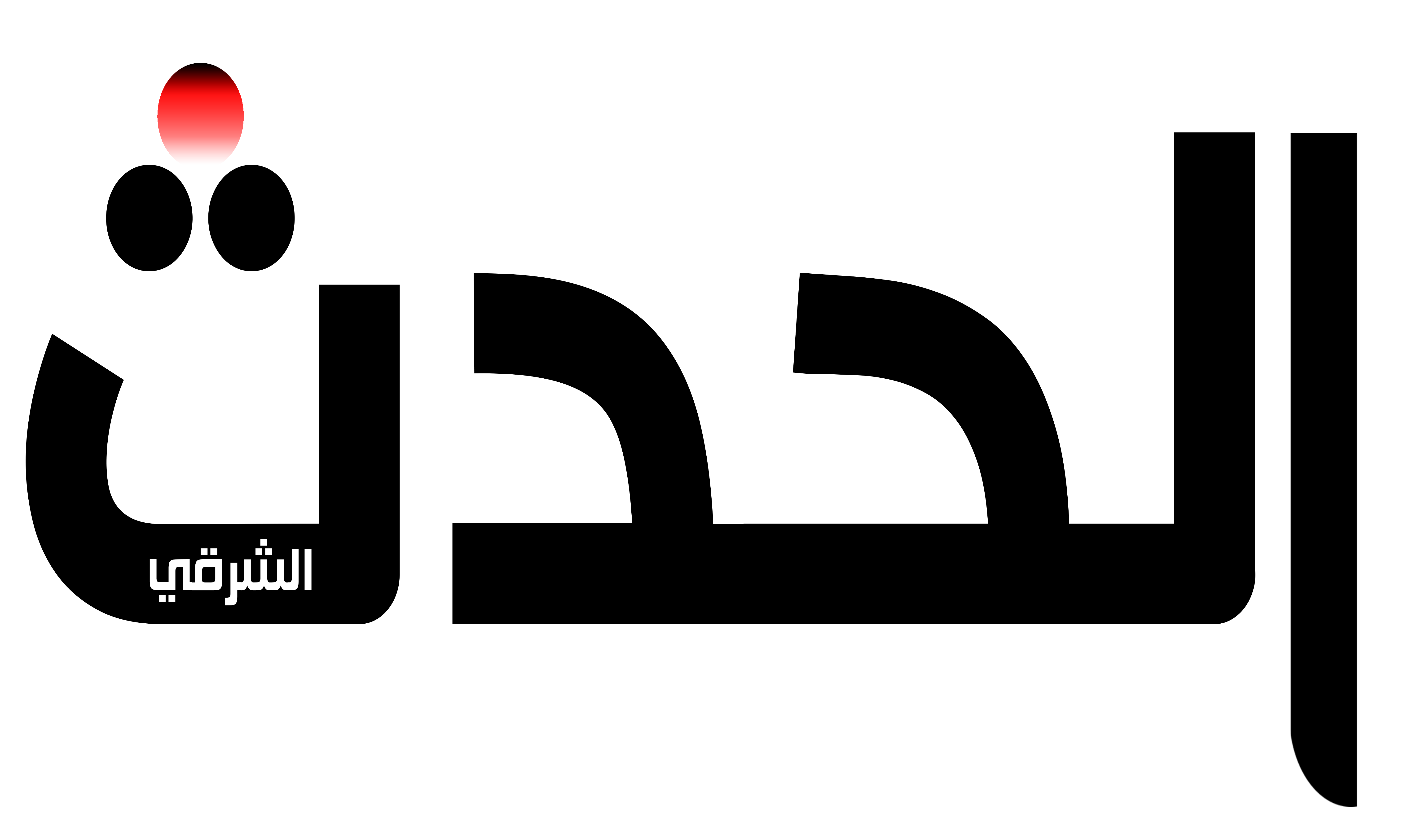بقلم: ذ/ رشيد خير
يقال إن المناسبة شرط، والمناسبة هنا هي النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة كأس إفريقيا للأمم التي احتضنها المغرب، والتي لم تكن مجرد دورة عابرة في كرة القدم، بقدر ما كانت حلبة للتنافس، بأبعاد وامتدادات تعدت حدود رقعة الملاعب. خرج فيها المغرب منتصرا أولا وبالدرجة الأولى على نفسه؛ فأكبر وأعظم الانتصارات هي تلك التي يحققها المرء ضد ذاته. ولا مبالغة في القول إن هذه الدورة شكلت لحظة فارقة في كرونولوجيا سائر نسخ المسابقة القارية منذ تاريخ إقرارها. وعلى الرغم من وجود من كان يكيد لها كيدا تمكنت من تحقيق قفزة نوعية، بوأتها مكانة مفصلية؛ معلنة بذلك -عاليا وبقوة- ميلادَ عهد جديد لهذه البطولة.
لقد حطمت الدورة كل الأرقام القياسية وتجاوزت سقف انتظارات المتتبعين وتوقعاتهم، سواء على مستوى جودة البنى التحتية أو على المستوى التقني واللوجستيكي والأمني وقس على ذلك … قدمت المملكة نموذجا تنظيميا تمت الإشادة به عالميا من طرف كل المنابر الإعلامية الجادة والموضوعية مع تسجيل استثناءات قلة؛ البعض منها لم يعد يفاجئُ أحدا، والتي كشفت عن بؤس احترافي وخِسٌٍ أخلاقي في تغطيتها للحدث. هكذا غردت خارج السرب تلك النفوس غير المطمئنة (بسكون الطاء وبفتحها تباعا)، الرسمي منها وغير الرسمي، منتهجة منطق التشويش والتضليل وإثارة البلبلة، فأطلقت العنان لكل أساليب التزييف والتحريف والتشويه والتدليس.
لماذا يصر البعض، إذن، على التشكيك في قيمة ما قدمه المغرب من إنجازات ومن أداء في التنظيم؟ ولماذا يعشق هؤلاء نقل التباري والتنافس من عالم الماديات، الملموسة والبادية للعيان، إلى عالم الهَلوسات التي لا وجود لها إلا في مخيلتهم أو عند من كان به فِصام أو ذُهان؟
إن الواقع أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الصحُف؛ وسلطانه أقوى من شطحاتهم الإعلامية. والحالة هاته، لم يجدوا أمامهم إلا إلباس ما اختلقوه من ذرائع لبوسا أخلاقيا بقصد النيل من نزاهة المنافسة؛ فاللجوء إلى محاكمة النوايا شأن دأبوا على السير في دهاليزه باعتباره حُجيةَ من لا حُجية له، ويُبقي لهم شيئا من الأمل لنفث سمومهم عبر نشر الإشاعة وتلفيق التهم، إذ تُنقَل المنازلة والمرافعة من سجل الملموس إلى سجل المدسوس. ومما لا شك فيه أن هذه الثنائية “ملموس/مدسوس” أو “مادي/أخلاقي” تشكل إحدى الأليات المفضلة لدى هؤلاء في مناوراتهم التضليلية وصرف الأنظار عما هو ثابت في الواقع.
هذه التصرفات النمطية ـ عندما تصبح قاعدة لا استثناءً ـ تكشف أعراضا وتعبيرات لحالة نفسية جلية، تتطلب منا وقفة للبحث في ماهيتها والكشف عن جذورها وفهم وظيفتها.
وإذا كان لقراءة هذه الأحداث فضل يذكر، فالفضل يعود لنباهة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه
(Friedrich Nietzsche) وما عرضه في مؤلفه الصادر سنة 1887 تحت عنوان “جنيالوجيا الأخلاق” (Généalogie de la morale).
نحن أمام ظاهرة سيكولوجية معروفة، تحمل إسم “الضغينة” (le ressentiment) والتي كان نيتشه من الرواد الذين اهتموا بدراستها ومفهمتها كما تناولها الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي، في وقت سابق، كتيمةٍ محورية في رواية “مذكرات قبو” (les carnets du sous sol). وقد اتسع نطاق توظيفها في حقول معرفية شتى كعلم النفس مع سيغموند فرويد (Sigmund Freud)، ونجدها أيضا في أعمال المؤرخ الفرنسي مارك فيرو ” Marc Ferro” في كتابه “الضغينة في التاريخ” (Le Ressentiment dans l’histoire) الذي نشره سنة 2007، معتبرا إياها عاملا، لا يقل أهمية، من بين العوامل التي أدت إلى نشوب نزاعات وحروب عبر التاريخ.
ما الضغينة وكيف تنشأ؟ هي حالة إفلاس نفسي معقدة تصيب الفرد كما تصيب الجماعات وتتجاوز مجرد شعور عابر ولحظي، فهي عبارة عن سيل جارف وهدام تتدافع فيه عدة إحساسات ممزوجة بالإحباط والحرقة الناتجين عن الفشل، مصحوبة بالانزعاج والقلق والغيرة والحسد إزاء ما يحققه الآخر من نجاحات، وتبلغ نقطة الذروة عندما تنصهر في شكل رغبة للنيل من هذا الآخر، فهي حالة أقرب من الحقد لكنها أعمق وأسوء منه بالنظر لطبيعتها المركبة ولما تخلفه من أضرار جانبية في نفوس أصحابها وفي محيطهم.
الضغينة رد فعل يلاحظ، عموما، في سلوكيات العاجزين والفاشلين أو المضطهدين والمقهورين، الذين تعوزهم القدرة على تحقيق ما يحققه غيرهم من إنجازات؛ خاصة عندما تكون محط تثمينٍ وإعجابٍ لدى المجتمعات وذات قيمة في مجالات كالسياسية والاقتصاد والثقافة والرياضة أو غيرها. وتتأجج كحالة نفسية لدى من يروج لخطاب هوياتي استعلائي ويصطدم بواقعٍ يعكس له صورة مغايرة لذلك. ومع توالي الإخفاقات وتعاقب الانكسارات تتسرب إحباطاته المتراكمة إلى غهايب النفس، فتترسب في ثناياها لتشكل بيئة حاضنة لنوع من الحقد الحاد والمزمن الذي يصبح جزءً من كينونته، والذي تغذيه نار الثنائية المكونة من “فشل ـ تفوق”؛ فشله طبعا وتفوق غيره. اجترار هذه الثنائية، لكونها باتت هاجسا لا يفارقه، يكلفه الشيء الكثير ويستنزف طاقاته، فلا اهتمام ولا شغل يصبح له إلا ما يحدث عند ذاك الآخر إلى حد نسيان ما هو أنفع وأجدى له ولعشيرته، فتُشَل روح المبادرة لديه ويظل غارقا في دوامة رد الفعل، باحثا عن شماعة يعلق عليها فشله. فبدل الإشادة بما يستحق الإشادة كما هو الحال عند الإنسان السوي، يلجأ من في قلبه ضغينة لاختلاق سرديات من وحي مخيلته لشيطنة خصومه وتبخيسهم أشياءَهم.
كيف تشتغل الضغينة؟ من الطبيعي لدى الإنسان أن تحركه نجاحات الآخرين، وعادي جدا أن توقظه وتلهمه في اتجاه الاستفادة من تجاربهم، لعل ذلك يسعفه في تحقيق ما يبتغيه؛ لكن الأمر يختلف تماما لدى من أفسدت الضغينة طويته.
ولعل أهم ما يميز الضغينة هو تلك الآثار الجانبية الناجمة عنها، وفي مقدمتها نزوح أصحابها إلى إلحاق الأذى بالآخر وتماديهم في “إنكار الواقع” (Le déni)؛ وأخطرها وأغربها ما تُحدِثه، بصفة آلية، من قلب على مستوى سلم القيم والأخلاق، نعرض فيما يلي لبعض الأمثلة للكشف عن ميكانيزماتها:
المتفوقُ متسلق ومتملق؛ القوي طاغية وجبروت؛ من نجمه سطع دفع؛ الظالم ضحية والعكس صحيح؛ حزن الآخر فرح لهم؛ الكياسة كولسة ليس إلا؛ الغني استغلالي ومرتشي؛ الإنصاف ليس عدالة بل تحيز وتحكم؛ كل متهم مدان حتى ولو ثبتت براءته، الحقيقة كذِب (قمة الاستهتار: ملعب المولى عبد الله واقف في شموخ اعتُبر صورة مفبركة صنيعة الذكاء الاصطناعي).
تلكم نماذج وضعيات غير حصرية لبعض ثنائيات الأضداد التي تُعد وقود المكينة التي تلازم الضغينة سقناها لتبيان دسائس لم تَعد خافية على أحد؛ يتم تجنيدها بشكل تلقائي كلما تعلق الأمر بما يستفزهم من نجاحات يحققها غيرهم.
ونقول في الختام لكل من تعرٌف نفسه فيما سبق: عندما لا تحتفي بالحياة، وبما يقوي الوجود ويسمو بالإنسان، ولا تتلذذ إلا بالجر والجذب إلى الأسفل؛ اعلم أن تصرفاتك تصرفات الضعفاء والفاشلين، ونقول لك بلسان نيتشه: أخلاقك “أخلاق العبيد”. فأما نحن، حتى وإن لم نوفق في تحقيق ما نصبو إليه، فنعتبر ذلك درسا يساعدنا على تجاوز ذواتنا. واثقون بأن “الضربة التي لا تقتلنا تقوينا”. ويسرنا أن ينطبق علينا ما عبر عنه الشاعر محمود درويش في إحدى قصائده “نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا”.