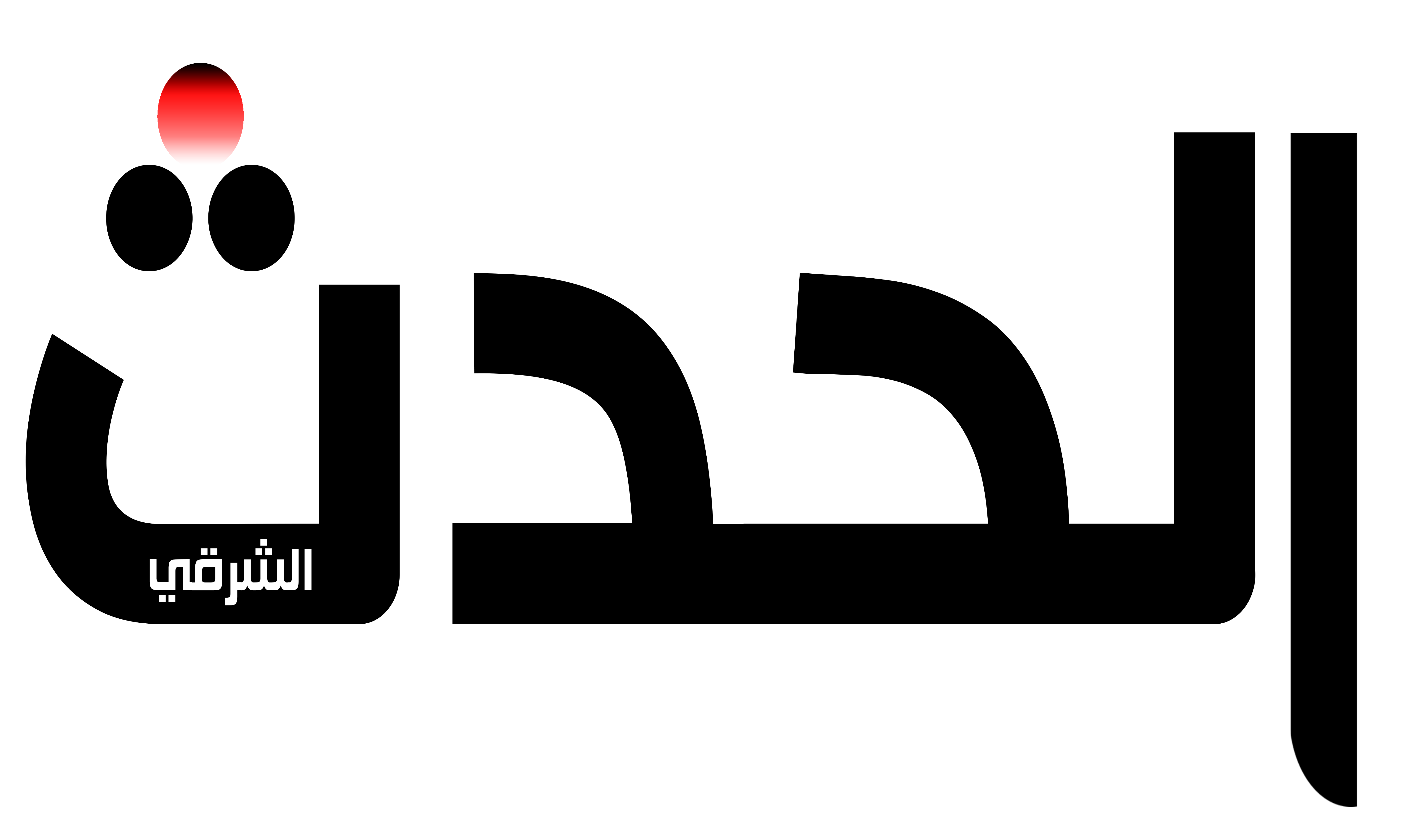ورالدين زاوش: عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة
تأثثت الساحة الفكرية والثقافية بالمغرب مؤخرا بمؤلف قيم من إصدار الكاتب المغربي “طيب دكار” الذي انتقى له عنوان: “عدم الاستقرار السياسي يديم القطيعة مع المغرب”، وهو كتاب تزيد صفحاته عن 400 صفحة من الحجم المتوسط، جمع فيه الكاتب ما يزيد عن 70 مقالا، مصاغا باللغة الفرنسية، كان قد نشرها في وقت سابق على منصات المواقع الإلكترونية، وجاء الكتاب في حلة راقية وبلغة بليغة ومعبرة ونافذة إلى عمق الموضوع، فضلا عن جمالية شكله.
تكمن أهمية هذا المنتوج الفكري المصبوغ بنكهة السياسة والتاريخ إلى عدة أسباب:
- رحابة مدارك الكاتب وسِعة اطلاعه في الموضوع؛ حيث إنه اشتغل كمراسل لوكالة الأنباء المغربية لسنوات طويلة قضى منها عشر سنوات بالجزائر العاصمة؛ مما جعله يخبر عن قرب طينة المسؤولين الجزائريين الرسميين وغير الرسميين، وكذا المثقفين والإعلاميين وعموم الشعب الجزائري، كما مكنته تجربة العشر سنين من فك شفرة الطغمة العسكرية الحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن للكاتب مؤلفات أخرى تتناول العلاقة مع الجزائر مما يؤيد أطروحة طول باعه وتخصصه في الموضوع.
- يمكن اعتبار الكتاب مرجعا يوثق لما سماه الكاتب “الجزائر الجديدة”، والتي انطلقت شرارتها مع انطلاق الحراك المبارك في الجزائر، كما يوثق أيضا لمسارات الأحداث الهامة والخطيرة التي طرأت ما بين تاريخ نشر أول مقال للكاتب في 3 أبريل 2019 إلى غاية 5 أبريل 2022.
- إن تزاحم الأحداث إبان هذه السنوات الثلاث الأخيرة، إن على المستوى الجزائري أو السياقات الإقليمية والعالمية الدقيقة، والمتمثلة في استشار وباء كوفيد 19، انطلاق الحراك الجزائري، الأزمة الاقتصادية الخانقة بالجزائر، التناحر على السلطة وتصفية الحسابات ما بين قيادات الطغمة العسكرية، الفشل الدبلوماسي الذريع في ملف الصحراء المغربية وغيرها.. جعل من هذا الكتاب أيقونة ثقافية وفكرية وسياسية لا يمكن إلا تثمينه وتهنئة صاحبه عليه.
رغم أن المؤلَّف تجميع لمقالات متفرقة تناولت أحداث الساعة في وقتها؛ إلا أن الكاتب نجح في جعل الكتاب فكرا مسترسلا ومتماسكا، وجعل له خيطا ناظما حيث إن القارئ لا يشعر بانقطاع المعنى وتهافت المبنى وهو ينتقل من مقال إلى آخر؛ وقد ساعده في ذلك، إضافة إلى خبرته وبراعته، كون الجزائر بقيت وفية “لدميتها” البوليساريو، حتى في أقسى الظروف وأحلك الأحوال، حيث في ظل أوج “الحراك المبارك” لم تتوقف الآلة الدبلوماسية الجزائرية الخارجية عن الترافع للنيل من الوحدة الترابية للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي، على حد تعبير الكاتب.
تحدث الكتاب عن التحاق الملايين من الشعب الجزائري ب”الحراك المبارك” الذي طالب بدولة مدنية بدل الدولة العسكرية التي أنشاها الديكتاتور بومدين وبقيت على حالها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، كما طالب بتنحي جميع القيادات السياسية والعسكرية عن السلطة تحت شعار “يَتْنَحّاو كاملين”، ومما زاد من توهج الحراك تزامنُه مع خروج الملايين من الشعب السوداني لانتزاع السلطة من يد المؤسسة العسكرية، وتفاعل هذه الأخيرة إيجابيا مع مطالب الشعب؛ إلا أن العسكر الجزائري أقصى ما كان يمكنه أن يقدمه إلى الشعب هو استقالة بوتفليقة، ثم انتخابات رئاسية مبكرة يشرف عليها الحرس القديم لإعادة إنتاج النظام القديم تحت مسمى “الجزائر الجديدة”.
يوضح الكتاب عبر مختلف فصوله ومقالاته أن عقيدة العسكر الجزائري ثابتة لا تتغير عبر السنين والعقود، وهي تنبني على ركيزتين: أولاها أن الديمقراطية ليست خيارا على الإطلاق في حسابات العسكر، مادامه غير قادر على أن يسود إلا بالحديد والنار، وثانيها أن المغرب عدو كلاسيكي ودائم مثلما قال شنقريحة في بدايات ظهوره بعد التخلص من الجنرال قايد صالح؛ أما باقي القرارات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية التي تفرزها الطغمة العسكرية الحاكمة فهي مجرد فرع ينبثق عن الأصل المتمثل في هذين الركيزتين الأساسيتين.
يؤكد الكاتب على أن حتى الرؤساء الذين تعاقبوا على شغل منصب الرئاسة في الجزائر، والذين لم يكونوا سوى الواجهة للطغمة العسكرية التي تحكم من وراء الستار، كانوا يتحسسون رؤوسهم إذا ما بدر منهم ما يؤشر على تقاربهم من المغرب؛ لأن ذلك يعتبر خرقا سافرا للركيزة الثانية التي تنبني عليها عقيدة العسكر، ألا وهي العداوة الدائمة والمستمرة للمغرب ومصالحه ووحدة ترابه بدون قيد أو شرط.
لقد اغتيل الرئيس محمد بوضياف على أعين ملايين الجزائريين لأنه بكل بساطة، حسب الكاتب دكار، حينما حضر لزفاف ابنه في القنيطرة التحق بالرباط لزيارة جلالة الملك الحسن الثاني، كما أن بوتفليقة صرّح يوما بأن إبداء موقفه الصريح من الصحراء المغربية قد يكلفه رأسه؛ هذا ما يفسر أيضا أن أهم ما كان يتم التركيز عليه في الحملات الانتخابية للرؤساء المرتقبين للجزائر، ليس مخططات إنعاش الاقتصاد المتهالك، أو إصلاح المنظومة الصحية وترميم البنية التحتية، أو تزويد السوق بما يفي بحاجيات المواطنين؛ بل تصريحاتهم المعادية للمغرب كصك براءة، يُقَدَّم للعسكر، من أي تقارب جزائري-مغربي محتمل، وفي الوقت ذاته، جواز عبور لشغل منصب الرئيس الشاغر؛ وهو ما أتقنه عبد المجيد تبون بامتياز حينما طالب في حملته الانتخابية المغرب بالاعتذار عما بدر منه إبان أحداث فندق إسني سنة 84 في مراكش.
رغم أن عداوة المغرب تكلف الخزينة الجزائرية مئات الملايير من الدولارات ما بين إطعام المُهَجَّرين قسرا في مخيمات تندوف وتطبيبهم وتدريسهم وتسليحهم، وبين رشوة اللوبيات الضاغطة في أمريكا لانتزاع قرارات في مجلس الأمن تحفظ ماء وجه العسكر؛ وكذا رشوة بعض الدول الإفريقية للتحكم في قرارات الاتحاد الإفريقي؛ ورغم أن الحراك أخرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه للشارع مطالبا بالحرية والكرامة؛ ورغم النقص المهول الذي جعل الشعب يصطف في طوابير طويلة، وكأنه إبان الحرب العالمية الثانية، لاقتناء نصيب زهيد من الحليب والزيت والطحين والمواد الأساسية؛ ورغم بلوغ الاقتصاد الحضيض والدبلوماسية الإفلاس؛ ورغم أن النظام البنكي الجزائري ما زال بدائيا ومتأخرا عن نظيره المغربي بأكثر من ثلاثة عقود؛ ورغم أن العالم كان متفرغا لتطعيم شعبه ضد وباء كوفيد 19، حسب الكاتب، فالطغمة العسكرية الجزائرية بالمقابل، متفرغة لنشر خطابات العدو الخارجي والكلاسيكي وكيده ومكره ومؤامرته ومخططاته الشيطانية والذي ليس سوى المغرب.
إن ما ساعد “المجلس العسكري” على ترويج خطابه، ونفث سمومه، وزرع مشاعر الكره والشنئان في صدور مواطنيه الأبرياء، هو ثلة من الصحافيين المنبثقين عن “جبهة التحرير الوطني” والذين استفادوا من الإمكانيات الضخمة التي كانت تضعها الدولة في متناولهم، كما أنهم تشبّعوا بفكر الحزب الواحد، وبالشعارات الرنانة من قبيل “الشعبية والتقدمية والديمقراطية”، وكذا شعار “من الشعب إلى الشعب”؛ إلا أنها تظل، حسب رأي الكاتب، مجرد شعارات جوفاء خالية المضمون، كما أنها تعبر عن حقبة الحرب الباردة التي ولَّى أمرها وانقضى أجلها؛ لكنها، للأسف الشديد، ما زالت تعشش في الرؤوس النتنة للعسكر وكأنها وليدة اللحظة.
إن الشعور بالنقص، والجزائر دولة أسسها المستعمر سنة 1962م، أمام دولة شريفة طاعنة في التاريخ جعل قياداتها تصرح بما لا يستسيغه عقل ولا يقبله منطق؛ فهذا “تبون” يُعْزي انتشار الإسلام في أوروبا إلى الجزائر، في حين يصر الكتاب الجزائريون على أن “حارة المغاربة” في القدس بناها الجزائريون، كما نشرت صحف جزائرية بأن الجزائر “مِن أوائل الدول إن لم تكن الأولى على الإطلاق” من اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن مسجد باريس تم بناؤه من طرف “قدور بن غبريط” الجزائري، بالإضافة إلى بناء جزء من جامع الأزهر بمصر، وجناح كامل من البيت الأبيض، ويمتد هذا الهراء إلى الفن والموسيقى والتاريخ، كما يؤكد الكاتب “دكار” على أن حتى مصطلح “المخزن” الذي يُسَوِّقه نظام العسكر وكذا مثقفوه أصحاب الشعارات الفارغة من قبيل “من الشعب إلى الشعب” على أنه وصف قدحي؛ هو في الحقيقة مدح لهذه المملكة الطاعن حكمها في التاريخ؛ لأن مصطلح “المخزن” إنما هو تعبير عن طريقة حكم امتدت لعدة قرون وليس لبضعة عقود.
يقف كتاب “عدم الاستقرار السياسي يديم القطيعة مع المغرب” عند محطات حاسمة ودقيقة كمحطة استرجاع مركز الكركرات بدون إطلاق رصاصة واحدة، من بين أيدي أفراد عصابة البوليساريو الذي فرُّوا كالجرذان مخلفين أحذيتهم خلفهم، الأمر الذي كان محل ترحيب دولي واسع؛ إلا أن قاسمة الظهر للدبلوماسية الجزائرية تمثلت في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل صحرائه في ديسمبر 2020م؛ مما جعل “المجلس العسكري” يصاب بالذعر والجنون، خصوصا وأن هذا الاعتراف مهَّد الطريق لفتح مجموعة من الدول الأوروبية والعربية قنصلياتها في الداخلة والعيون..
إن الضربة الموجعة التي تلقَّتها المخابرات العسكرية الجزائرية وكذا نظيرتها الإسبانية من لدن المخابرات المغربية، إثر كشف هذه الأخيرة للمحاولة السرية لتهريب رئيس البوليساريو لإسبانيا من أجل التداوي تحت اسم مزيف، كان له بالغ الأثر في إعادة قاطرة الدبلوماسية الإسبانية اتجاه قضية الصحراء المغربية على السكة الصحيحة من جديد، حيث إن رئيس الحكومة الإسبانية “سونشيز” حاول، بعد هذا الحادث، الاستمرار في اعتماد خطاب الضبابية واللعب على وترين في قضية الصحراء كالعادة؛ إلا أنه وجد نفسه، حسب الكاتب دكار، مضطرا للاعتراف بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، خصوصا وأنه تيقن من أن المغرب لن يقبل إلا بشريك أكثر وضوحا واتزانا في علاقاته الخارجية معه.
يؤكد الكاتب “دكار”، بنوع من السخرية أحيانا، إلى أن حبل المشنقة يلتف حول عنق “المجلس العسكري” أكثر فأكثر، فيتحدث عن “القوة الضاربة” التي لا تتوفر على طائرات “الكندر” لإطفاء الحرائق حتى مات مواطنوها حرقا واختناقا، ولا توفر المواد الأساسية لمواطنيها حتى ماتوا جوعا وقهرا، ولا تأبه بتطعيمهم ضد الوباء، ولا تلتفت إلى مطالبهم من الحرية والكرامة؛ بل وتقتل منهم 250.000 إثر العشرية السوداء، الأمر الذي لا يمكن أن يقع إلا في الجزائر، كما أنها ترسل عشرات الجنرالات والوزراء ورئيسي حكومة سابقين إلى السجن ، فقط من أجل تزيين الواجهة وذر الرماد في أعين “الحراك المبارك” أملا في انطفاء جدوته وامتصاص غضب رُواده.
إن الأزمة الخانقة التي يعيشها “المجلس العسكري” على جميع الأصعدة جعله يشير بأصابع الاتهام إلى العدو الكلاسيكي (المغرب) في كل ما يُلم به من نكبات وانتكاسات؛ فالحرائق التي اندلعت في منطقة “لَقْبايل” أشعل شرارتها المغرب بواسطة طائرات “دْرون” الإسرائيلية، وتقرير البنك الدولي السيء حول الوضعية الكارثية للاقتصاد الجزائري تم بإيعاز من المغرب، وتقارير حقوق الإنسان حول الانتهاكات الجسيمة لنظام العسكر الجزائري اتجاه مواطنيه صدر بضغط من الدبلوماسية المغربية، ليستطرد الكاتب “دكار” بعد ذلك: “إذا كان الأمر كذلك فالمغرب هو “القوة الضاربة” التي تتحكم في كل شيء وليست الجزائر”.
طيلة فصول الكتاب، أكد الأستاذ “دكار” على أن الجزائر ما زالت تعيش في “جلباب أبيها” حيث إن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي وضعه المغرب بين أيدي المنتظم الدولي سنة 2007م لقي ترحيبا واسعا على أساس أنه مقترح واعد، واقعي، عادل وقابل للتحقيق، عكس المقترح الجزائري الذي تجاوزه الزمان مثلما تجاوز عقلية العسكر البائدة؛ فالعسكر ما زال قابعا في اقتراح “تقرير المصير” الذي أثبت عدم قابليته للتطبيق، في محاولة بائسة لإرجاع عقارب الساعة ثلاثة عقود للوراء.
هكذا تبنت ألمانيا مقترح المغرب كحل وحيد وأوحد للنزاع المفتعل، يشير الكاتب، كما أجمع كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة العربية ومنظمة الدول الإسلامية ومجلس الأمن على نجاعة مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ومنصف، ومن شأنه إرساء السلم والأمن في منطقة الساحل، ولم يتبق بجوار “المجلس العسكري” الجزائري المنعزل سوى دولة جنوب إفريقيا وبضع دول إفريقية تعيش على الهبات الجزائرية على حساب الحاجيات الأساسية للمواطنين الجزائريين.
لقد قام النظام الجزائري بمجهود دبلوماسي خارق قبيل انعقاد مجلس الأمن، وأرسل مبعوثيه فوق العادة، مثلما يصفهم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم وزير الخارجية “رمطان لعمامرة” من أجل استراك فشله الذريع، وعزلته المحبطة التي جناها جراء خياراته البليدة وعناده منقطع النظير، وطبعا لن يكون هذا إلا ب”إلقاء من النافذة”، حسب تعبير الكاتب، لبضعة ملايين من الدولات الإضافية في جيوب لوبيات الضغط الأمريكية علها تؤثر على مسار جلسة مجلس الأمن الحاسمة.
لقد كان قرار مجلس الأمن 26.02 صادما “للمجلس العسكري” ومخيبا للآمال العريضة، حيث أكد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الصيغة الواقعية لحل النزاع المفتعل ضاربا بذلك عرض الحائط أسطوانة “تقرير المصير” المشروخة؛ من المؤكد أن “المجلس العسكري” لن يرفع الراية البيضاء ويسلم بالأمر الواقع قريبا؛ لأنه حسب الكاتب، لم يهيئ نفسه للبحث عن بدائل في حالة فشل أطروحته من جهة، ومن جهة أخرى لأن مفهوم “النيف” “Nif” هو أسمى ما يمتلكه الجزائريون وأعز ما يتغنون به.
لم يفت الكاتب “دكار” أن يُذَكِّر، كلما سنحت له الفرصة، بأن مواقف العداء اتجاه المغرب كانت ترتفع حدتها كلما ألمت بالنظام الجزائري أزمة خانقة أو نكبة خارقة؛ ومن أجل أن يمتص غضب الشعب ويضمن وحدة الجيش فهو يعمل جاهدا على لفت الانتباه إلى “العدو الكلاسيكي” بكيل الاتهامات له بلا رقيب أو حسيب، مثلما اتهمه بالتجسس على رؤساء الدول باستعمال البرنامج الإسرائيلي “بيكاسوس”، وكذا اتهامه بإيواء الإرهابيين الذين قتلوا أصحاب الشاحنات الجزائرية القادمة من موريتانيا؛ ليتضح فيما بعد بأن كل هذه الاتهامات مجرد دخان بلا نار.
حينما تجد زعيم “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” عباس المدني عندما أتى على ذكر الحسن الثاني أرْدف ذكر اسمه ب”رضي الله عنه”، وهي الصيغة التي تُستعمل عادة حينما يُذكر صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسب الكاتب، وحينما تجد الجالية الجزائرية في الخارج تهتف باسم “سيدنا”، إثر تدخل جلالة الملك محمد السادس لتسهيل عبور جاليته لأرض الوطن، في الوقت الذي كان فيه “المجلس العسكري” منشغل بتزوير وثائق رئيس البوليساريو من أجل تهريبه للتداوي، تفهم دون أن تتفهم، حجم الحقد الدفين الذي تكنه هذه الطغمة العسكرية للمملكة المغربية الشريفة، وتفهم أيضا حجم الهجمة الشرسة على شخص “سيدنا” في القنوات التلفزية الجزائرية من لدن شخص لم يتعرف على مذاق الموز إلا في سن الثلاثين، على حد تعبير الكاتب.
أما تبرير الشنآن اتجاه المغرب بواقعة حرب الرمال التي جرت سنة 1963م، والتي لا يكل من التباكي حولها نظام العسكر لإثارة غضب الشعب وتهييج مشاعر الانتقام لديه تحت شعار: “المرّوك حْقرنا”، حيث إن الجنود المغاربة اقتحموا الحدود الجزائرية بين ليلة وضحاها، واستولوا على مناطق واسعة داخلها، وأسروا المئات من جنود “القوة الضاربة”، ولم يطلق سراحهم إلا بواسطةٍ سعودية؛ فيؤكد الكاتب أن الجزائر هي من بدأت الحرب بقتل العشرات من الجنود المغاربة والهجوم بالطائرة على بعض مناطقه الحدودية؛ ورغم أن الحسن الثاني أرسل وزير الخارجية أنذاك “أحمد بلا فرج” بمعية مستشاره “عبد الهادي بوطالب” إلى الرئيس “بن بلة” لتقصي الأمر؛ إلا أن هذا الأخير رفض استقبالهم في المرة الأولى، ولم يمنع هذا الحسن الثاني من إعادة الكرة بإرسال “عبد الهادي بوطالب” بمعية قائد عسكري رفيع؛ ورغم أن الرئيس “بن بلة” استقبلهما هذه المرة؛ إلا أنه تجاهل الأمر ولم يقدم أي اعتذار أو حتى مجرد تفسير لما وقع وكأن لا شيء قد وقع؛ فنالت “القوة الضاربة” ما تستحقه؛ هذا ما سطره “بوطالب” في كتابه: “نصف قرن بين ألغاز السياسة”.
هكذا، وبإبداع منقطع النظير، يفند الكاتب تصريح بوتفليقة الذي أدلى به في مطار الرباط بأن الجزائر “لا ناقة لها ولا جمل” في الصحراء، ويؤكد، بما لا يدع مجالا لأدنى شك، بأن البوليساريو إنما صنيعة الدكتاتور بومدين، وأن الجزائر حاضنته ومسلحته وممثلته في الداخل والخارج، كما يخلص الكاتب إلى قاعدة ذهبية مفادها: “لا تغيير في سياسة الجزائر التي صاغها الدكتاتور بومدين اتجاه المغرب، ولا وحدة مغاربية تلوح في الأفق إلا بعد أن تتمتع شعوب المنطقة بالقدر الكافي من الحرية والديمقراطية، والذي يسمح لها باختيار مسؤوليها المدنيين بكل حرية وشفافية ونزاهة، وأن أي وحدة أو تقارب خارج هذا الإطار يبقى ضربا من الأحلام الزائفة غير قابلة للتحقق“.
نورالدين زاوش
عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة