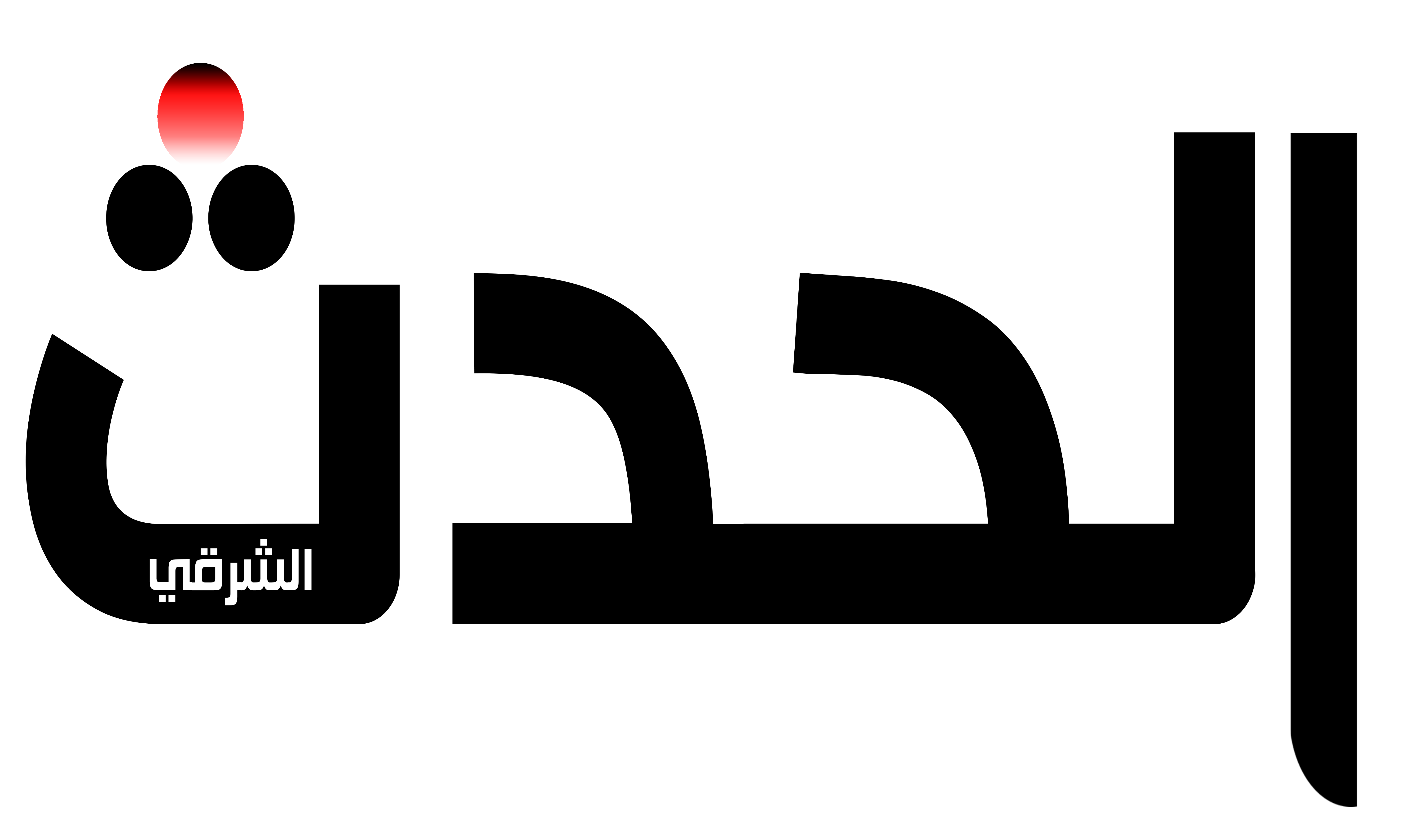بقلم: رضوان قرشاوي
تدخل الجزائر في مرحلة الانتخابات الرئاسية بعد أشهر قليلة، لكن الانتخابات هذه المرة ليست كسابقاتها؛ لأنها لا تهم عملية تقنية لاختيار رئيس الجمهورية، بل سبقها وسيوازيها وسينجم عنها وضع يجعل مستقبل الجزائر على مفترق طريقين، إما استمرار النموذج الحالي بخصائصه ومقوماته، أو الانفلات نحو مسار غير واضح المعالم.
ومن ذلك، يجب أولا أن نحدد مقومات النظام السياسي الذي يحدد النموذج الانتخابي، قبل الحديث عن مجمل العوائق التي يمكن أن تحد من فاعليته وجاذبيته بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
– مقومات النظام السياسي الجزائري
يقوم النظام السياسي على ركائز محددة ومرتبطة تجمعها غاية التنظيم المتمثل في استمرار النمط أو النموذج السياسي، في دولة الاستقلال، وهو فعلا يعتبر من الأنظمة المرنة التي استطاعت أن تتجاوز انهيارات المنظومة الاشتراكية للعوامل التالية:
العامل الأول، هو ارتكاز الدولة على قدر من الوحدة النفسية المرتبطة بعدالة قيام الدولة، والمتمثلة أساسا في مفهوم الشرعية، حيث إن غياب إرث تاريخي كبير دفع السياسيين إلى صناعة الملحمة ارتباطا بالاستعمار الفرنسي. فقد نشأت الجزائر الحديثة، كأغلب الدول العربية والإفريقية، بعد نهاية الاستعمار الأوربي والفرنسي على وجه التحديد، وقد كان للاستعمار بها خصائص متعددة؛ فهو من جهة كان يبتغي الاستمرار باعتبار هذه المنطقة الجغرافية تابعة للجمهورية الفرنسية، وهو ما كان يصطلح عليه بالجزائر الفرنسية. ومن جهة أخرى كان الاستعمار يمزج بين الثقافي والحضاري، وهو ما كون شخصية وطنية منفصمة بين المفاهيم الغربية ونظيرتها المأخوذة من القيم الهوياتية العربية الإسلامية. وآخر الخصائص التي عقبت الاستعمار هي قيام الدولة كجهاز بطريقة عنيفة عقب حرب تحرير خلفت من بين ما خلفت أكثر من مليون شهيد حسب تصريحات غير دقيقة هنا وهناك.
الجزائر دولة تعيش مع الماضي بشكل دائم ومرتبط بقيم الدولة ذاتها، ولم تستطع أن تتجاوز حقبة الاحتلال الفرنسي على المستوى النفسي على الأقل. وبدل أن يصبح الشهداء محور المستقبل رهنت الجزائر مستقبلها بماضيها وجعلته هو الثورة وحراس الثورة وخدامها، الذين تحول بعضهم إلى حرس قديم لمفاهيم قارة تجعل من السياسة ميدانا لحراسة المفاهيم التقليدية للدولة ومنطلقا لشرعيتها.
في الجزائر تعيش سلفية السياسة؛ عموما لا يمكن أن تكون إسلاميا ولا شيوعيا ولا ليبراليا، ولا يمكن الإيمان بتوجه نظري غير تلك التي ترهنه بمسار طويل ابتدأ منذ الاستقلال وقبله أحيانا جعل السياسة في عقول الجزائريين هي الدولة وقيم الثورة.
العامل الثاني، مرتبط بمكتسبات ومنطلقات النظام الجزائري ومفهوم القوة والاستقرار القائم على القدرة على التحكم في المحيط الإقليمي؛ من جهة عملت الجزائر على استبعاد المنافسة مع دول الجوار ومنها أساسا تونس والمغرب باستراتيجيتي التقزيم ودعم الانفصال. ومن جهة أخرى اعتبرت الجزائر مفهوم القوة مرهون، إضافة للعامل الجغرافي، باكتساب التحكم في الطاقة التي تتوفر عليها وتتحكم فيها بشكل كبير.
أما العامل الأخير، فهو ارتكاز المنتظم السياسي على فكرة الاستقرار الداخلي وفق نمط قار ومتحكم فيه يقوم على لاعدالة التوزيع السلطوي للقيم بين مكونات الشعب الجزائري، وينهض على توزيع الثروة على المستوى الدولي بما يضمن الولاء الخارجي. ويحمى ذلك بمؤسسات مدنية وعسكرية، عسكريا هناك جهازان غاية في التنظيم والتعقيد؛ من جهة مؤسسة الجيش، ومن جهة أخرى مؤسسة المخابرات باختلاف تخصصاتها، أما المؤسسة المدنية الأضخم فهي حزب جبهة التحرير الوطني التي كانت هي الحزب الوحيد إبان مرحلة الصراع شرق غرب.
فهل يمكن أن يستمر النظام بمقوماته التقليدية بعد الانتخابات المرتقبة؟
– مرض الرئيس أم انهيار نموذج؟
الإيمان بالمؤسسات يدفع إلى الحديث عن طبيعة تفاعل المعنيين بالانتخابات الجزائرية الرئاسية؛ ومن هذه الزاوية يبدو أن المعركة هي بين حزب جبهة التحرير الوطني وبين باقي الأحزاب، والتي يظهر أنها لم تعد تؤمن بقدرتها على مجابهة الآلة التي لا تنهزم، المتمثلة في جبهة التحرير الوطني.
اللعبة الانتخابية حول الرئاسيات هي فقط للكبار من مؤسستي الجيش والداخلية، ويعتقد أن الاختلاف حول الشخصية التي خلفت بوتفليقة ليس حول الطريقة بل حول الاسم فقط، وهو ما أخرج “تبون” للعلن. فقبل الإعلان الرسمي لترشحه مرة أخرى بدا جليا عدم التوافق بيم مؤسستي الجيش وكبار مسؤولي الداخلية الذين كانوا أكثر تحفظا على إعادة بوتفليقة لكرسي الرئاسة، لكن الإصرار الذي برهن عليه المراهنون على الرئيس المنتهية ولايته دفعه لإعلان ترشيحه رسميا يوم السبت 22 فبراير 2014، ليقدم ملفه رسميا لرئيس المجلس الدستوري في 03 مارس من نفس السنة. ويبدو أن العملية تتكرر مع الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بصيغ لا تختلف عن سابقاتها.
وقبل سنوات كان النزال الداخلي بين التيارين الكبريين في دواليب السلطة الذي دار بين جناح بوتفليقة، الذي كان قد التألم أيام مشروع الوئام المدني والمصالحة الجزئية مع نهاية تسعينيات القرن العشرين، وجناح المخابرات التي تعد المركز الأول للقرار بالجزائر، والتي كانت قد تحكمت منذ مدة في جزائر الاستقلال عندما أسس عبد الحفيظ بوصوف سنة 1958 ما سمي بوزارة التسليح والعلاقات العامة داخل جهاز جيش التحرير الوطني، وهي أصل جهازي الأمن العسكري ومديرية الاستعلامات والأمن الحاليتين، وتعتبر واحدة من أقوى الأجهزة الاستخباراتية على المستوى الدولي وليس فقط العربي.
وكان قد تبين من خلال التعديل الوزاري لسنة 2013 من خلال التركيبة الحكومية مدى النفوذ الذي حققه أنصار “اتجاه الوئام المدني” ومدى الزحف على المؤسسات الذي تحقق؛ من جهة تم تنصيب أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورمطان العمامرة وزيرا للخارجية، وعموما عكست التعيينات القوة الحقيقية للتيار النافذ الحقيقي بالجزائر. وبقي عبد المالك سلال رئيسا للوزراء كتعبير عن استمرارية تحمي مصالح أطراف أخرى، لكن الهدف كان هو رئيس المخابرات الجزائرية الذي تعرض بدوره لهجومات متتالية لم تكن كفيلة بتنحيته من صراع الأجنحة غير القار وغير المتزن منذ مرض الرئيس بوتفليقة آنذاك.
وقد جاءت تصريحات عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في غمرة السباق نحو الرئاسة لتعزيز ضبابية المشهد داخل الجزائر، فقد هاجم مباشرة رئيس مديرية الاستعلامات والأمن محمد مدين المعروف حركيا بتوفيق، وهو واحد من عرابي الجزائر ما بعد انتخابات 1992، أو ما يعرف بالشرطة السياسية للبلاد، عندما اعتبر أن الجهاز يسيطر على كافة دواليب الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وقد وازى ذلك نشر خبر في جريدة “الخبر” مفاده أن الرئيس قد عزل جنرال المخابرات القوي من منصبه (راجع جريدة الخبر الجزائرية يوم الخميس 06 فبراير 2014)، وقد تنبه الأطراف إلى خطورة الهجوم على المخابرات دون ضمانات للجيش، وقد عبر عن ذلك أحمد محمدي الذي كان أودع ترشيحه حيث أكد “أن هذه التصريحات تهدف إلى إحداث شرخ بين الشعب والجيش، وزعزعة الوحدة بين الجزائريين الذي يضمنها الجيش”. وبالتالي تمت المسارعة للتخفيف من هذا المنحى بإصدار بلاغ رئاسة الجمهورية، بعد حادث سقوط طائرة عسكرية في 11 فبراير (شباط)، حيث دعا إلى عدم المس بنزاهة الأجهزة العسكرية التابعة للدولة. لكن، عموما جرى العرف بهذه الدولة على أن تكرار اسم المسؤولين الأمنيين إعلاميا يعني فقدان الحماية من “المنتظم” العميق للدولة. ولعل ذلك يجعل التساؤل يتكرر حول التنسيق بين مختلف الاتجاهات في الجزائر وما إن كانت اتجاهات بتحالفات قارة؟
لا تختلف الأمور اليوم في الجزائر فهي تستعد لانتخابات جديدة هذه السنة، وبعد أشهر قليلة، ولكن على وقع اختلاف كبير بين أجنحة الجيش بالخصوص، حيث وصل الأمر إلى محاولة اغتيال السعيد شنقريحة قبل أشهر قليلة وهو ما يعني وجود استعداد كبير للدخول في مسارات متعرجة بين دروب الجيش الوطني، وكذا سعي أطراف مدنية محسوبة على اتجاهات ذات ولاءات أجنبية إلى التأثير لتغيير مجريات الأمور، وهي لن تجد مناسبة أفضل من الانتخابات الرئاسية.
وقد تمر هذه الانتخابات “التبونية” تحت وقع الزغاريد كما حدث في انتخاب “تبون” سابقا، والدولة في حاجة إلى ذلك وسط الكوارث في السياسات الداخلية والفشل الديبلوماسي الشنيع لها دوليا، لكن ذلك لن يغير من واقع الأزمة المستفحلة بالبلاد.
الأساس هو إعادة بوصلة التوجهات الكبرى للدولة التي تاهت بعد الصراع العسكري الداخلي بين الجماعات المسلحة وأجهزة الدولة التقليدية لأكثر من 10 سنوات، والتوجه العام على الأقل بين تيار إصلاحي يدعو إلى اعتماد أساليب مستحدثة لتكريس مبادئ الدولة الحديثة، وهو للإشارة لا يتمثل بالجيش كمؤسسة، وهو اتجاه يعمل على تكريس استمرار تحكم مؤسسات بعينها في ظل وضع غير ديمقراطي. ولذلك جاءت بعض التصريحات التي ترى في استمرار تبون استمرارا للنموذج الثاني، وهناك من دعا سابقا إلى إسقاط النظام الجزائري الحالي بأسلوب هادئ يكون فيه دور مركزي للجيش، قائلا “هذا النظام تآكل وسيسقط لذلك، وأنا أريد إسقاطه بأسلوب هادئ وبقرارات، وليس بموجة هوجاء”، وهي دعوة مباشرة للانتفاضة ضد النموذج الحالي.